
عزيز لزرق: أساتذة النظام الأساسي.. أبطال بلا مجد...
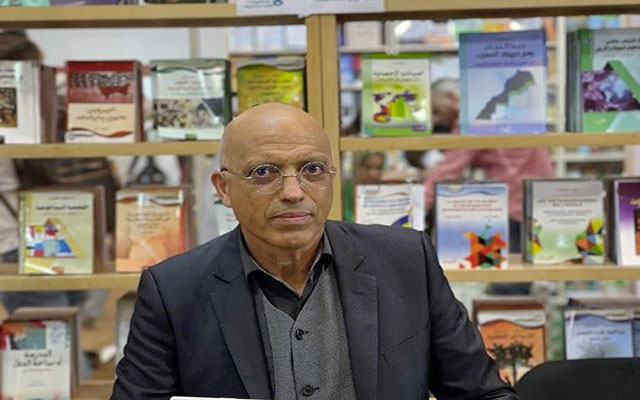 عزيز لزرق
عزيز لزرق

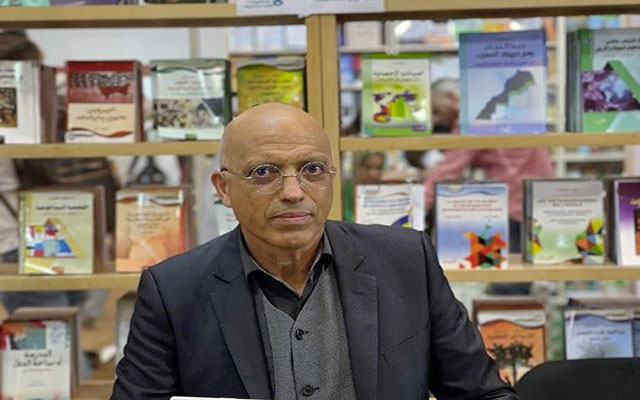 عزيز لزرق
عزيز لزرق
يحظى التعليم بإجماع وطني مزدوج: الإجماع على أهمية القضية من جهة، والإجماع على جرح المنظومة وخرابها، من جهة ثانية. هكذا تم التطبيع مع هذه المنظومة الجريحة والمخربة، واستدخل الجميع مواتها. نحن أمام نسق تعليمي منخور، يعيش أزمة خانقة وفشلا ذريعا، على مستوى ربط التعلم بالتربية، ومد الجسور بين المدرسة والمجتمع، وإرساء علاقة سليمة بين الشخص و ذاته، و بين الفرد و الجماعة. يتعلق الأمر بوضعية شبحية وسديمية، حيث تبدو المؤسسات مجرد بنايات تفتقد للحياة، تعاقبت عليه سياسات إصلاحية، فاشلة في منطلقاتها ومخرجاتها: الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي و الرؤية الاستراتيجية. وفي الوقت الذي كان من المنتظر والمأمول، أن يفتح النظام الأساسي بعض ممكنات التغيير الإيجابي، أدخل هذا النظام الوضع التعليمي في حالة احتقان، لا يمكن التكهن بمآلها، بسبب ظرفية وطريقة النزول ومحتوات التنزيل. وقد قوبل ذلك بموجة غضب عارمة، وبتصعيد احتجاجي لا يمكن التعامل معه بمنطق اللامبالاة سواء من طرف الوزارة الوصية، أو من طرف الحكومة ككل، و لا نستسيغ الرد على هذه الاشكال التعبيرية النضالية التي يقوم بها نساء ورجال التعليم، بالانفراد و احتكار وسائل الإعلام الرسمية، للدفاع عن المرسوم الحكومي، و بالإقدام على محاولات فاشلة في التأثير على الرأي العام. ولتعميق النقاش بصدد هكذا احتقان مجتمعي، وليس فقط قطاعي، يتعين تقديم التوضيحات التالية:
إنّ النظام الأساسي ليس نصا مقدسا محصنا من الوقوع في الخطأ، بل هو مشروع حكومي يتضمن اقتراحات قد لا تكون كلها ملاءمة، وقد يتعرض بعضها لسوء التقدير وحتى الوقوع في الخطأ. وهذا ما يجعل النظام الأساسي مجرد من القدسية مثله مثل باقي القوانين الوضعية. عندما نعتبر القانون مفروضا ويملى من الأعلى، فإننا نعلن مسبقا على كون أي نقاش هو تشكيك في القدسية. إن زواج عبارتي النظام والأساسي، تكثيف للحضور الدلالي للقدسية، فمناقشة النظام تحيل في لاوعي السلطة إلى عدم التقيد بواجب الطاعة، وبالتالي الإخلال بالأمن العام، و لأن مهندسي الإصلاح ينطلقون من استدخال تمثل قبلي للخطوط الحمراء و للبديهيات، فكل اعتراض على الأساسي يعني تجاوز حدود هذه الخطوط الحمراء، التي لا يجوز أن تكون موضع نقاش عمومي. لذا من الأفضل تعويض عبارة النظام الأساسي "بالإطار التنظيمي لموظفي قطاع التربية الوطنية". وبالتالي فتسريع تنزيل "النظام الأساسي"، قبل فتح وتعميم النقاش بصدده من طرف المعنيين، حوله إلى نوع من الإنزال، الذي يخاطب الأستاذ ليس كفاعل ومفعل، بل كمنفذ طيع لمجريات أي إصلاح.
يدعي النظام غير الأساسي أنه يقوم على مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، بينما الأمر يتعلق بخدعة التشاركية، فكيف يمكن الحديث عن تشاركية، إذا كان نساء ورجال التعليم، مبعدين عن المشاركة ومحرومين حتى من حق الإخبار، فلا الوزارة أطلعت المعنيين بالأمر على مشروع مقترحها، ولا النقابات أخبرت قواعدها بمجريات اللقاءات مع الوزارة، ولم تقدم لهم الصيغة الأخيرة المترتبة عن هذه اللقاءات، قبل التوقيع عليها. إننا أمام إشراك محدد المنطلقات والغايات، وليس تشارك، وبالتالي أمام مجرد تشاور لا يرقى إلى مستوى التقرير بكل ما يعني ذلك من قوة التفاوض والقدرة على الدفاع الفعلي عن المطالب المشروعة. ومن تم فنحن لسنا أمام مقاربة تشاركية، بل أمام إشراك رمزي، غايته إضفاء الشرعية على مرسوم حكومي مقدس، واستشارة أقرب إلى الإخبار دون أن تكون للمعنيين أية سلطة في اتخاذ القرار، لأنها مجرد استشارة لا تلزم الأخذ بها. بينما المقاربة التشاركية الفعلية تستلزم إعطاء المعنيين جزء من السلطة تسمح لهم حقا بمراقبة القرار المتخذ وفتح نقاش عمومي بصدد هذا النظام المرسوم المقترح، وليس استعجال اقتراح مشروع مرسوم بقانون، والإسراع بعرضه على مجلس الحكومة، والتهافت على إنزاله وفرض أمر الواقع.
إن أحد تداعيات الوضع المأزوم في التعليم يتمثل، في ضعف الفعل النقابي وبرودة بريقه النضالي، وعلى المؤسسة الوصية أن تعيد النظر في مرجعية "النقابات الأكثر تمثيلية"، إن كانت حقا جادة في فتح حوار حقيقي مع المعنيين بالأمر. فالشريحة الجديدة من الأساتذة، قاعدتها شبابية، وسيتم توظيف أزيد من 200000 أستاذ بحلول 2030، وبالتالي ستكون الشريحة الشبابية تشكل 80% من مجموع الأساتذة ككل. وعلى الوزارة الوصية أن تأخذ هذا البراميتر بعين الاعتبار، في ما تدعيه من "مقاربة تشاركية". علينا ألا ننسى أن الجيل السبعيني و حتى الثمانيني من الأساتذة كان شبابيا، يحمل في أحشائه بذرة التغيير و الحلم بالديموقراطية. لكن طبيعة المرحلة الآن تغيرت جعلت الشباب والأساتذة الشباب تحديدا لا يؤمنون بالتغيير الجذري للمجتمع، ولا يطرحون الثورة كرهان تاكتيكي سياسي لانتزاع المطالب، إنهم مثقلون بالاستياء النضالي و بكساد اليوطوبيات، لكن هذا لم ينقص من جذوتهم النضالية، لذا اختاروا إطارا آخر، مادامت الأجهزة الحالية لا تتلاءم مع مطالبهم المباشرة و الملموسة، يتعلق الأمر بالتزام حر، بعيدا عن أية وصاية أو صرامة تنظيمية. إنهم يؤمنون بقدرة الفرد والأفراد، أكثر من قدرة الجماعة والإطار، ويعتبرون التنسيق بين الأفراد، أهم معبر للتأثير في الجماعة، وليس العكس كما كان سابقا، من هنا نفهم الدلالة العميقة لعبارة " التنسيقية". إنهم جيل شبابي بارع في تقنيات التواصل والتكنولوجيات الجديدة، لذا يأخذون القرار بسرعة ويمرون إلى الفعل، بنوع من المقاربة التشاركية، التي تسمح لكل واحد و للجميع التعبير عن رأيه و المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار اللازم. على الوزارة أن تنتبه لهذه الدينامية الجديدة، لكي لا تسقط في فخ صراع الأجيال، و لكي لا تخطء الهدف في اختيار المحاور، و لكي لا تتمادى في خدعة الإشراك الشكلي. إن أي حوار يقصي حضور الجيل الشبابي من الأساتذة، و أي نظام أساسي لا يستحضر هذا المكون الديموغرافي، سيظل مجرد جسم غريب، لن تنجح زراعة الإصلاح في استنباته.
يدعي النظام الأساسي أنه يسعى إلى تجديد مهن التدريس والتكوين، من أجل إرساء إصلاح تربوي، يكون فيه المدرس فاعلا رئيسيا وضامنا للجودة. وهنا يتعين أن لا نفصل بين الأستاذ كفاعل رئيسي و بين النسق ككل، فهو ليس ساحرا و فعاليته و جودة أدائه رهينة بالسياسة التعليمة ككل، و على رأسها الاشتغال على استرجاع السلطة الرمزية للمدرس داخل الحقل التعليمي و داخل المجتمع ككل. والاشتغال على استرجاع جذوة الدراسة وشغف المعرفة وتحرير المدرسة من النزعة الانتقائية المتوحشة، و تخليصها من هذا التجريد العاطفي الذي حولها إلى مجرد هيكل محنط تعمره هيئة متعبة من المدرسين في وضعية سيزيفية غير قادرة على بث روح الحياة فيه. فالحديث عن جاذبية المدرس يستلزم تحقق شرط جاذبية المدرسة. كما يتعين في هذا الصدد ان نميز بين المهنة وبين العمل، و بالتالي أن نميز بين جاذبية المهنة، و جاذبية العمل، فقد يكون الأستاذ منجذبا لمهنته و يحبها، لكنه غير منجذب لعمله و ينفر من ممارسته، فجاذبية المهنة لا يمكن أن تخلق جاذبية العمل، إنها شرط لازم (أو غير لازم بالنسبة للبعض) لكنه غير كاف لوحده، كي يكون المدرس فاعلا و مؤثرا في المشهد التعليمي، أما جاذبية العمل فيمكن أن تخلق جاذبية المهنة، إنها شرط لازم للجميع و كاف إذا أراد المدرس تحقيق الجودة. فجاذبية المهنة رهينة بدوافع ذاتية ترتبط بصورة المدرس عن ذاته ومهمته، وبمكانته الاعتبارية داخل المجتمع و في سياسة الدولة. وجاذبية العمل رهينة بدوافع موضوعية، يمكن تكثيفها فيما يعرف بالإيرغونوميا أو بيئة العمل، ونقصد أثر علاقة المدرس مع محيط عمله، وداخل فضاء عمله (طبيعة الأقسام و مدى توفر التكنولوجية الحديثة، و الفضاء العام داخل المدرسة، و ما يتضمنه من تجهيزات، إضافة إلى عدد الساعات و عدد الأقسام...)، و بما يتوفر له من مكتسبات و من أجر و تعويضات و من تحفيزات و تكوينات.
يحدد النظام الأساسي مرجعيته من خلال النموذج التنموي الجديد، الذي يدعو إلى تحقيق "نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم" على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وعلى ضوء ثنائية الجزاء والعقاب. يبدو أن النظام الأساسي تبنى مقاربة أمنية في معالجة الاختلالات المتراكمة، تستخدم مرجعيتين ثاويتين: المرجعية الاقتصادية (المردودية والجزاء)، والمرجعية القضائية (العقوبات التأديبية). وبالتالي قلص من مجال الحقوق، وأفاض كثيرا في الحديث عن الواجبات و المهام، مختزلا الجزاء في التحفيز، و مختزلا التحفيز في الترقية. وهنا يتعين التنبيه إلى ما يلي:
1 غموض بعض الصياغات وفتحها عل كل الاحتمالات: "تضع السلطة الحكومية مدونة لأخلاقيات المهنة"، إنه انفراد في سلطة التقرير لا تلزمها بمشاركة المعنيين بالأمر، ولا تحدد محتويات هذه المدونة. كما أن النظام الأساسي يلزم المدرس بأشياء ويجرد نفسه من ضرورة الالتزام بما يقره "وضع المعطيات والمستجدات التربوية والموارد الديداكتيكية والبيداغوجية، في حدود الإمكانات المتاحة." كما يحدد لمدرس مهمة لا يمكن حصر تداعياتها وقابلة للتنزيل بالشكل الذي يرضي مهندسي المراقبة والعقاب: "المشاركة في عملية التنمية والتطوير المهني".
2 الترقية ليست تحفيزا بل حقا، كما أن مطلب الزيادة في الأجر حقا وليس تحفيزا. أما التحفيز فهو ما يكون موازيا للحقوق بالنسبة للجميع، إنه ما يمكن أن يستفيد منه البعض، شريطة أن يكون متاحا للجميع، الترقية حق عام، والتحفيز حق استثنائي خاص، و يمكن أن يكون هذا التحفيز في نوعين: تحفيز معنوي: تقليص ساعات العمل عموما، تقليص ساعات العمل كلما تقدم المدرس في سنوات العمل، حيث تتقلص بشكل تصاعدي، الاستفادة لسنة واحدة في المسار المهني من رخصة مؤدى عنها، لاعتبارات خاصة دراسية أو تكوينية. الإعفاء من القسم في السنتين الأخيرتين من مسار المدرس، والتفرغ لمهام تأطيرية، حسب رغبة المعني بالأمر، الاحتفاء سنويا بمسارات تدريسية متميزة، وبتجارب إبداعية متفردة، تنظيم لقاءات تكريمية تصون كرامة المدرس وتعترف بخدماته الجليلة، عوض الشكل البئيس الذي يودع به المدرس عمله....
تحفيز مادي: يمكن أن يتخذ أشكالا متنوعة من التعويضات، كالتعويض عن المنطقة أو التعويض عن التنقل في حالة التدريس في مؤسستين (من أجل إكمال جدول الحصص)، التعويض عن الهندام و أجهزة التكنولوجيا الحديثة، التعويض عن اقتناء الكتب و المرجعيات، التعويض عن شهر جزافي (الشهر 13)، التمييز بين المهام الضرورية للتربية و التدريس و المهام غير الإلزامية، و بالتالي يتعين تخصيص من جهة تعويض متعلق بتداعيات المهام الضرورية (الحراسة و التصحيح)، فأوقات العمل بالنسبة للمدرس لا تتحدد فقط في الزمن المدرسي و جدول الحصص، بل يشتغل المدرس في زمن قبلي لتهيئ الدروس، و يشتغل في زمن بعدي لتصحيح الفروض. وتخصيص من جهة ثانية تعويض عن المهام غير الإلزامية (الدعم وتنظيم الامتحانات والمباريات والمشاركة في الأنشطة المدرسية والموازية، والتكوينات). لنشير مثلا إلى نظام التعويضات في فرنسا (و هو أقل بكثير من دول أخرى مثل ألمانيا)، حيث نجد تعويضات خاصة عن متابعة و مرافقة التلاميذ (ISAE) وتعويضات عن متابعة و توجيه التلاميذ (ISOE) و ساعات إضافية فعلية من أجل القيام بمهام إضافية (HSE -HSA) وتعويض عن مهام استثنائية ( IMP )
3 العقوبات ليست معالجة تربوية للاختلالات بل تعبير عن حس انتقامي، يتم فيه المس بالحقوق و المكتسبات: إن الباب التاسع الخاص بالعقوبات التأديبية، وحده كاف لضرب جاذبية المهنة، إنه أكثر باب يسئ للأسرة التعليمية للاعتبارات التالية: إنه لا يتحدث عن الأخطاء المهنية و أصنافها، لا يتبنى مقاربة علاجية تصحيحية لما يمكن أن يقع فيه المدرس من أخطاء مقصودة أو غير مقصودة، و لا يسمح بهامش مقبول للخطأ، و عوض صيغة المجالس التأديبية، باستعمال لغة زجرية: العقوبات التأديبية، و كأننا أمام إصلاحية و ليس بصدد إصلاح تربوي. ولأن النظام الأساسي متلهف للتهديد والوعيد، فهو أبدع في تحديد أربع درجات من العقوبات، و اجتهد في تمديد أصناف العقوبات، لكي تصل إلى 16 عقوبة. ولأن الهدف هو التخويف والتطويع، وليس الغاية هي التحفيز والجودة، فقد حدد النظام الأساسي هذه العقوبات، دون أن يحدد المخالفات، إنها عقوبات صارمة، تم توقيعها على بياض، فقد عرفنا كيف سيعاقب المدرس قبليا، دون أن نعرف الحالات التي ينبغي أن يعاقب فيها، يتعلق الأمر بعقوبة بدون موضوع. وهذا تعبير عن قهر مبطن. علاوة على ذلك فكل العقوبات فيها مس بالحقوق: الحق في الانتقال والحق في الترقي والحق في الاستقرار المالي (التراجع عن الرتبة). لقد تحول الأستاذ من فاعل رئيسي في المنظومة، إلى متهم رئيسي إلى أن تثبت براءته أو إدانته، أصبح للأستاذ داخل هذه المقاربة الأمنية و الزجرية العقابية، سجلا عدليا، مع إعطاءه الحق في الاستفادة من العفو و محو العقوبات!!! متى حصل على شهادات حسن السلوك (التشجيع و التنويه و ميزة الشرف) !!!
من بين الغايات التي يسعى النظام الأساسي إلى تحقيقها غاية " التوحيد"، و يبدو أنه نجح في تجسيدها بشكل غير مسبوق، من خلال هذا الرفض الموحد للنظام الأساسي، فقد توحد جميع الأساتذة، و انضمت إليهم المنظمات النقابية، التي كانت مشاركة في المسلسل التشاوري، الكل يعلن بصوت واحد رفض مضامين هذا النظام. إن "النهضة التربوية" و"الإصلاح التربوي" و" إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي"، كما يزعم مهندسو الإصلاح، لا تتم بقرار سلطوي معزول، و لا ينبغي أن نمرره بفرض الأمر الواقع، و بمنطق "المخزن التعليمي". لا يمكن أن نكره المعنيين على التقيد بنظام لا يرونه مشروعا، و يعتبرونه لا يستجيب لمنتظراتهم حيث كانوا يعلقون آمالهم على هكذا توافق تنظيمي، من أجل حل المشكلات و تجاوز الاختلالات. لا نريد نظاما يتشبث بشكل صنمي بمواده و لا يراعي روح القانون، و لا نريد إصلاحا معطوبا "يخرج من الخيمة مائلا"، لا نريد المزيد من الهدر الزمني و من استنزاف الجهود و الإجهاز على الطموح و شل الفاعلية وقتل الرغبة، لا نريد أن ننطلق في مشروع فاشل لا يفي بالغرض، لكي نعود مرة أخرى للبحث عن إصلاح الإصلاح. لا نريد أستاذا مهزوما أمام سلطة القرار، مقهورا وسط شراسة الواقع اليومي، لا نريد أستاذا مكسور الخاطر، مهيض الجناح، لا يمكن أن يتحقق الإصلاح والتغيير بدون أبطاله الأساتذة، لكن لا يستقيم أن يرسم النظام ملامح أبطال بدون مجد.
لكل هذه الاعتبارات يتعين إيجاد مخرج حكيم لفتح الحوار و النقاش، و لتبادل الإنصات و التراضي، من أجل إرساء مدرسة عمومية أكثر جودة و جاذبية، بفضل أساتذتها تزرع بذور الحلم الأمل و و تقطف ثمار النجاح و التألق، فعلى قدر أهل المجد تأتي الأمجاد....